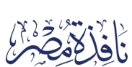تقول الكاتبة تاتيانا سفورو إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 9 أكتوبر 2025 جاء بعد مفاوضات طويلة توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، وأسفرت عن اتفاق “مرحلة أولى” رعته قطر ومصر وأقرّته الأمم المتحدة. نص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من وسط وجنوب القطاع، والسماح بعودة المدنيين المهجّرين إلى الشمال، وزيادة المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، مقابل إفراج حماس عن الرهائن الإسرائيليين المتبقّين، وتحرير أسرى فلسطينيين على مراحل.
ومع ذلك، وفق ميدل إيست مونيتور، استقبل الفلسطينيون والمنظمات الإنسانية هذا الاتفاق بحذر لا بارتياح، إذ ما يزال أكثر من 1.9 مليون مواطن من غزة مهجّرين، والبنية التحتية مدمّرة على نحو يجعل أجزاءً واسعة من القطاع غير صالحة للحياة حتى في ظل الهدنة. ويعيد الاتفاق إنتاج البنية نفسها التي حكمت غزة لعقود، إذ يركّز على الترتيبات الأمنية وتدفق المساعدات المشروطة، متجاهلًا العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب المحتملة.
تشير سفورو إلى أن القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، يحظران العقاب الجماعي واستهداف المدنيين وتدمير مقوّمات الحياة. ومع ذلك، تستمر الانتهاكات تحت ذرائع “الدفاع عن النفس” و”الأمن”، في ظل غياب تطبيق فعلي للقانون. فمحكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لمنع أعمال الإبادة وتسهيل المساعدات، لكنها لم تواجه أي ضغط حقيقي لتنفيذ ذلك، ما يكشف أزمة ثقة في جدوى القانون الدولي نفسه، إذ صيغ هذا النظام في الأصل لإدارة الشعوب المستعمَرة أكثر مما صيغ لحمايتها.
وترى الكاتبة أن الهدنة بالنسبة إلى سكان غزة تمثل تعليقًا مؤقتًا للعنف لا تحوّلًا جذريًا في الواقع. فقرابة 90% من سكان القطاع نزحوا من بيوتهم، وأكثر من 82% من أراضيه تقع ضمن مناطق إخلاء أو عسكرية، وبلغت قيمة الأضرار المادية نحو 30 مليار دولار وفق تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة. ويعيش أكثر من نصف مليون شخص في حالة مجاعة منذ أغسطس 2025. وتؤكد سفورو أن الإبادة لا تقتصر على القتل المباشر، بل تشمل تدمير البنية الاجتماعية والثقافية والمادية التي تتيح للحياة الجماعية أن تستمر. ومن هذا المنظور، لا ينهي وقف إطلاق النار عملية الإبادة، بل يبطئ إيقاعها.
أما الخطاب الإنساني، فيتحوّل – حسب المقال – إلى بديل عن السياسة. فالمساعدات تُقدَّم تعويضًا أخلاقيًا لا تغييرًا بنيويًا، والرعاية تحل محل العدالة، بينما تُستخدم المشاعر لتغطية غياب الإرادة السياسية. يظهر ذلك بوضوح في غزة، حيث يفضّل المجتمع الدولي الحديث عن “الإغاثة” بدلًا من “المسؤولية”، فيتعامل مع الفلسطينيين كضحايا يحتاجون المساعدة لا كفاعلين سياسيين يملكون حق تقرير المصير.
وترى الكاتبة أن العنف المادي قد يهدأ، لكن المنظومة التي تولّده تبقى قائمة: الحصار، المصادرة، والحرمان المنهجي من مقوّمات الحياة. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا توقفت الإبادة، بل إن كانت قادرة على “الانتهاء” أصلًا بينما تظل هندستها السياسية والأمنية قائمة. تتحكم القوى المهيمنة في من يعيش ومن يُمحى، وتحافظ على غزة كحيّز يُدار لا كوطن يُعاش، حيث تُحفظ الحياة عند حافة الفناء.
ويكشف الموقف الدولي، كما تقول سفورو، انهيار فكرة القانون كقيد على السلطة. فقرارات المحكمة الدولية ومواد اتفاقية الإبادة لم تُترجم إلى عقوبات، بل اكتفت الدول بتعبيرات “القلق” فيما واصلت تزويد إسرائيل بالسلاح. بذلك يتضح أن تطبيق القانون انتقائي، وأن “النظام القائم على القواعد” لا يشمل الجميع. فالقانون، كما يراه المنظور الاستعماري، امتياز يُمنح للبعض ويُسحب من آخرين، وتجسّد غزة هذا التناقض في أوضح صوره.
وتخلص الكاتبة إلى أن تكرار مفردات “عملية السلام” و”خفض التصعيد” يخفي حقيقة أن السلام، كما صيغ في النموذج التقليدي منذ أوسلو، ليس تحررًا بل إدارة للصراع. فالهدنة الحالية، شأنها شأن اتفاقيات سابقة، تقدّم الصمت كسلام وتُبقي البنية التي تنتج العنف على حالها. السلام الحقيقي لا يقوم على تهدئة النار، بل على اقتلاع أسبابها: إنهاء الاحتلال، تفكيك نظام الفصل، ومساءلة الجناة، وضمان حق الفلسطينيين في السيادة بوصفه مبدأً غير قابل للتفاوض.
https://www.middleeastmonitor.com/20251010-could-silence-be-mistaken-for-peace-the-grammar-of-accountability-in-gaza/